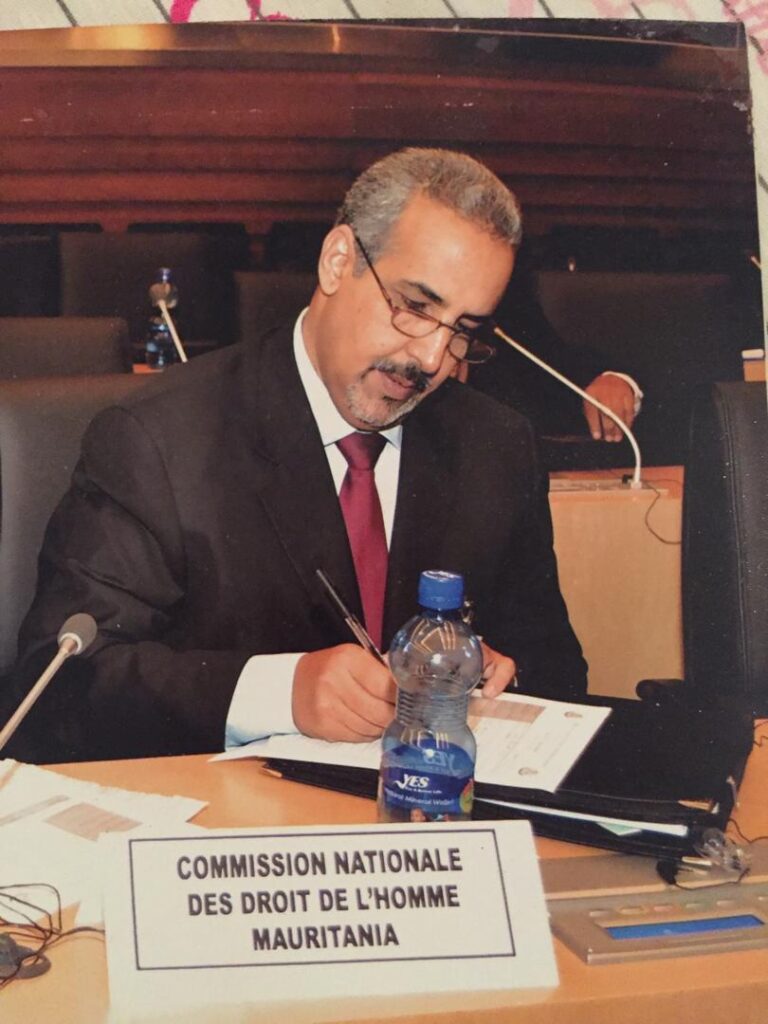انتظمت المناقشة العمومية الغربية الراهنة ضمن حدود فلسفتي السياسة والقانون وبين هذين الحدين نجد مكانة مرموقة تحتلها العلوم الاجتماعية في هذا الانتظام شديد الخصوصية .
ومن هذا المنظور برز فيلسوف التواصل الفيلسوف الألماني
يورغن هابرماس Jürgen Habermas 1929-…) متوكئا على هذه الخلفيات النظرية والمفهومية وإن كان استلهم أيضا من الفلسفة الكانطية على مستوى فلسفة الأخلاق وهو استلهام امتد حتى إلى الفلسفية السياسية الآمريكية المعاصرة وتحديدا جون رولز John Rawls .
الواقع أن أخلاق التواصل التي نشدها هابرماس تستلزم أدوات كانطية عتيدة على غرار الفضاء العمومي ففي الحقيقة لا يمكن أن تتم أي عملية تواصلية تداولية خارجه ونحن نعلم أن كانط هو “أول الفلاسفة المحدثين الذين فكروا فلسفيا في الفضاء العمومي”.
سيطور هابرماس بلا شك هذه المفاهيم وسيحدد أفق الترجمة كناغم للمتواصلين في الفضاء العمومي والذي وسعه ليشمل كل الذوات الحديثة التي تمتلك أداة التواصل وتضع في الاعتبار حيز الاختلاف لكنه مع ذلك اشتغل ضمن الدرب الذي خط كانط ترسيماته ومكن لمقاساته ببراعة شديدة .
أما بخصوص مفهومي الحوار والتشاور فإننا يمكن أن نرصد تمايزا في المفهومين ومماسفة طويلة بين الحقول التي يتظنن قبوع الحل فيها لمناقشة هكذا مفاهيم أو وضعها على الأقل ضمن أشكلتها الصحيحة نظريا .
فلا نكاد نعثر لذكر كبير لمفهوم التشاور ضمن الحقول الفلسفية النظرية و بخلاف مفهوم الحوار يبدو التشاور مفهوما فنيا أكثر منه مفهوم اصطفافيا أو حتى مفهوما تأويليا ولعل أهم ميادين هذا المفهوم هو الأدبيات الدبلوماسية السياسية أو حتى الاجتماعية وإن كان قد حمل معنى في التراث السياسي الإسلامي أكثر اتساعا غير أن الشورى بقيت في مفهوميتها العامة النظرية والتاريخية رهن ماهو تشاوري بالمفهوم التقني .
أما مفهوم الحوار فإنه يحمل معنى التقابل البيني الذي لا يتسلح نظريا بغير علاقة لغوية هي المشترك والوسيط و ذوات عقلانية تريد البناء على هذه المشترك اللغوي الجزئي من أجل الوصول إلى مشترك دلالي وأنطولوجي أكثر اتساعا وهو ما يتطلب جهدا كبيرا من هذه الذوات سواء على مستوى ما هو فني يتعلق بترجمة هذه اللغة إلى وسيط واضح أو حتى تحديد الآفاق التي ينتظم ضمنها النقاش بدء ومختتما .
فهل يحتاج النظام الموريتاني الحالي للحوار أم للتشاور ؟
هذا التقديم النظري كان ضروريا من أجل الوصول إلى هذا الإشكال ومما لاريب فيه أن النظام الموريتاني وما أحاط به نفسه من مفهوم قلق للإجماع -يتحاج هو الآخر لبحث أكثر استفاضة لا يتناسب مع هذا السياق- لم يستطع أن يقدم نفسه باعتباره نظام مجاوزة لمعظم المشاكسات الاجتماعية والسياسية ولم يلبث هذا الإجماع إلى أن تحول إلى مشكل مجابهة ومباينة بحاجة هي نفسها لمناظرة تعيد تشكيل وترتيب هذا الإجماع من جديد وفق آلية يراها بعض الأطراف حوارا ويتمسك البعض الآخر بالتشاور من منطلق الفنية والابتعاد عن غموض مفهوم الحوار نظريا وإرثه تاريخيا ثم والأهم من ذلك عدم وضوح رؤية كلا الأطراف بإطاره الغائي وحدود موضوعاته ومآلاته .
إن التأسيس على سؤالنا أعلاه سيمكننا من تأكيد مصادرتين أوليتين لا بد من الوقوف عندهما :
1-أن المشكلات الاجتماعية والهووية الكبرى لا يمكن حلها بجلسة حوار أو مدونة إجرائية باردة وإنما تتطلب الوعي الكياني الشامل بضرورة المشترك باعتباره المقدس الذي لا يمكن الوجود خارجه ولا يمكن البحث عن الإصلاحات بدون الانزواء تحت مظلته والمقصود هاهنا هو الدولة باعتبارها الكيان الذي يجد كل من الحوار التشاور دلالتهما فيه
2-أن الدولة بطبعها كمؤسسة ليست منوطة بخلق الوعي وإنما هدفها هو المحافظة عليه وكل المحاولات الراديكالية التي كان الوعي أو التنوير فيها مؤسسيا باءت بالفشل ذلك أن الوعي القويم لا يكون إلا داخليا ناهيك عن أنه متزمن باستمرار ويتحرك بكل بطء نحو غايات ذاته لكنه يظل في حركة مستمرة لا تعرف النكوص .
بالإنطلاق من هاتين المصادريتين يمكننا القول إن أي إخلال بكونية الدولة كمشترك وغاية أو فرض الوعي عبر ورشة مناكفات بيروقراطية أو مدونات إجرائية لن يكون له كبير نفع في الوصول إلى الحلول المرجوة .
وسواء اعتمد النظام الحالي على آلية التشاور التي نراها أكثر تناسبا مع سياق تثبيت المصادرتين خاصة أن بعض الأطراف حملت في الآونة الأخيرة شعارات جذرية تحضر فيها مفاهيم الانفصال و القلب والتباين الهوياتي فإن الأمر لن يحمل أية نتائج ملموسة مالم ينفتح النظام الحالي على أطراف جديدة بدأت هي الأخرى تأخذ حيزها من النقاش العمومي على غرار النسوية و المدنون وحتى اللامنتمون الذين لم يجدو ضمن الخارطة السياسية والحقوقية أي تمثيل مريح لهم وهم كثرة بدأ صمتها يأخذ شكل تنمر واضح .
و مالم يتجاوز النظام أيضا فكرة تثبيت الإجماع الذي لا وجود له من الأساس فإنه لن يستيطع تثبيت وجوده الفعلي .
بقي فقط أن نؤكد أن الدرس الكبير والملهم الذي أبانت عنه نتائج الانتخابات التشريعية المغربية الأخيرة يؤكد أن رهان العصر اليوم لم يعد رهانا إيديولوجيا أو سياسيا وإنما هو بالدرجة الأولى رهان تنموي فلم يعد الناخب ينتظر من أي نظام سياسي أكثر من مقاربات تنموية تعود عليه في رفاهه الاجتماعي ومقاربات أخرى حقوقية تمسه في حقوقه الاجتماعية وحين تتحقق هذه المقاربات لن تكون هنالك حاجة كبيرة إلى أي مناظرة سياسية أو اجتماعية وإنما سيتحول النظام إلى كتلة نشاطية حارة تكسب الإجماع الفعلي من وجودها المؤسسي و الخدمي .