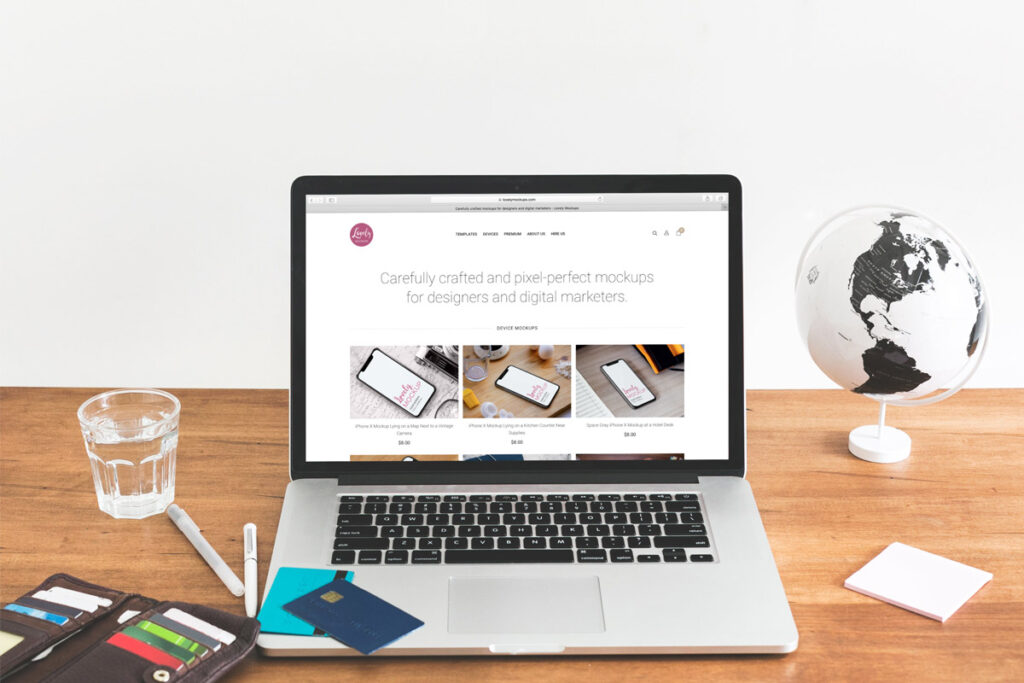عبد الودود ولد الشيخ، العالم الاجتماع الموريتاني، والقامة الفكرية والفلسفية الباسقة، و روضة العطاء العلمي الضافية الأفياء، التي لاتنضب.. رجل أضاعه قومه، رغم أنه ممن يشار إليه بالبنان حيثما حل او ارتحل في اصقاع العالم..ناضل في بلاده رغم شح الظروف وظلم ذوي القربى على أن يجعل لـ “البحث العلمي” فيها نواة، ولكن نفسه الأبية عن الضيم وجدت في الأرض منأى لها عن بلاد يظلم فيها المواطن بسبب لونه او عرقه.
معه تكرع في جدول فكري رقراق لا ينضب.. ومعه تتجسد امامك قيم الحداثة والاستنارة الفكرية.. ومعه تستصغر الجبال أمام عظمة تواضعه وخلقه الكريم.
في هذه المقابلة التي اجرتها معه صحيفة تقدمي يستعرض الدكتور عبد الودود ولد الشيخ رؤيته انتروبولوجية، تطبعها الدقة والموضوعية، حول الفضاء الموريتاني بعلاقات وروابط مجتمع البيضان الداخلية “مجتمع السيبة”وممارساته المختلفة كالعبودية و العنصرية “التطهير العرقي في سنوات 1989″الارهاب الاسلامي”الجهادي”الربيع العربي.. “وواقع المراة “.
البروفوسور الجامعي وعضو كوليج دي فرانس Collège de France “مختبر الانتروبولوجيا الاجتماعية” هو من يستعرض لنا في هذه المقابلة آرائه وأفكاره السهلة، الممتنعة.
فحول أسطورة الصراع المعروف بـ”حرب شرببه” الذي أسس لميلاد علاقات جديدة بين الزوايا وحسان يجيب عبد الودود ولد الشيخ بنسبية قائلا “هناك مجموعات كانت في الوقت ذاته تعد من “حسان” كما تعد من “الزوايا”، وكذلك يمكن أن يولد الفرد “حسانيا” ويصبح فيما بعد “زاويا” (جراء التوبة أو الهجرة)، كما يمكن أن يولد “حسانيا” ويصبح “لحميا” أو يولد “لحميا” ويكتسب مكانة “الحساني” ، الخ. كما أن الانتساب لـ”العرب” أو “البربر” أو “السود” لم يكن يلعب دورا حاسما في المسألة، فهناك “حسانيون” ينسبون لصنهاجة، وزوايا ينتسبون لبني حسان و لحمه ينسبون لهذا الأصل تارة ولذاك تارة أخرى، وما إلى ذلك.
ويضيف عبد الودود ولد الشيخ أن”إن علاج الآثار النفسية والاجتماعية للعبودية (العنصرية والاحتقار والاستبعاد من الزواج، الخ.) غير ممكنة فيما يبدو لي قبل فترة (جد) طويلة، ما لم تأت الظروف بثورة اجتماعية. ومع ذلك فإن جملة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة والموجهة نحو ترقية تلك الفئة (تنفيذ إصلاح عقاري حقيقي وآليات قرض محددة، الخ.) يمكن أن تساعد على التقليل من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الحراطين، ومن ثم تخفيف التوترات التي تولدها هذه الصعوبات أو التي يمكن أن تولدها في المستقبل”.
وحول سؤال الهوية الوطنية وخاصة جانبه المتعلق بالتعايش بين مكونات المجتمع الموريتاني يتطرق ولد الشيخ للعلاقات التاريخية بين المجتمعات التي عمرت الفضاء الموريتاني قائلا”لم أعثر، في أي من الوثائق التاريخية التي قدر لي أن أطالعها، على نزاع أو حرب على أسس عرقية بشكل صريح.
“وبعودتنا إلى العصر الحديث يرى الانتروبولوجي انه مرغم على ملاحظة أنه خلال “احداث”نهاية الثمانينات :سنلاحظ بداية لتطهير عرقي إداري بمختلف أشكاله: تسفير جماعي لمواطنين موريتانيين من قومية الزنوج، والقيام باعمال تصفية خارج القانون تمس بصفة خاصة المنخرطين منهم في صفوف الجيش.
وحول مجمل هذه المواضيع وغيرها وعلى الرغم من صفته الدولية ومكانته العلمية يتحدث عبد الودود ولد الشيخ بالكثير من التواضع والبساطة مذكرا أكثر من مرة ب”وضعيته كمنفي خارج الوطن” وابتعاده عن الساحة السياسية الموريتانية بما يترتب عليه خطر التشويه الناجم عن كونه “نتاجا للثقافة الاستعمارية الفرنسية”.
مرة اخرى هذه المقابلة تلقى الضوء بصفة نقدية وموثقة على العديد من القضايا التي تعيشها الساحة السياسية الموريتانية الحالية
نص الحوار:
اجرى الحوار: حنفي/ عباس
عبد الودود ولد الشيخ، هلا حدثتنا عن البيئة التي نشأت فيها؟
أنا مولود تحت خيمة، غير بعيد من بئر الميمون القبلي الرعوية ، حوالي سبعين كيلومترا شمالي بوتلميت، في عائلة من البدو الرحل شبه المستقرين، أقرب إلى الفقر منها إلى الغنى، تنتمي إلى طبقة الزوايا التقليدية. وكانت قيم هذا الوسط، المرتبطة ارتباطا قويا بروح انتماء طبقي يستمد مشروعيته من النسب، تسيطر عليها التقوى الإسلامية والمكانة المميزة التي يحظى بها طلب المعارف التقليدية العربية والإسلامية في نسختها المحلية. وكانت تراتبيات الطبقة الاجتماعية و السن والجنس تفرض عليها سلوكا صارما يمليه ذلك النوع الخاص من الحياء الذي كان يدعى السحوة. ولو أن الأمور أخذت “مجراها التقليدي”، لكان علي أن أتعلم رعاية المواشي وحفظ أهم نصوص المناهج الدراسية التقليدية: القرآن والأخضري وابن عاشر والألفية وخليل، الخ. لكن مهاراتي كراع متدرب كانت متواضعة شيئا ما (أذكر أنني أضعت مرة واحدا من “المراكيب” أي أحد الجمال يتخذ كمطية كنت أرعاه…). ولكن قربى النسب والجوار مع بعض الأوساط المقربة من الإدارة، إلى جانب الآثار الاقتصادية الكارثية لأزمة بداية الأربعينات من القرن الماضي، دفعت بعض أفراد أسرتي للانضمام إلى المدرسة الاستعمارية في بوتلميت، ثم جاء دوري لأدخل تلك المدرسة في سن مبكرة نسبيا قبل أن أبدأ بجدية – للأسف – تكوين” ولد الزوايا” التعليمي، كما كان يقال حينها.
قبل سنوات، استقلت من عملك كمدير للمعهد الموريتاني للبحث العلمي. ماذا لو أخبرتنا عن الأسباب التي أدت إلى تلك الاستقالة، وبوجه عام عن الصعوبات التي يواجهها البحث العلمي في موريتانيا، فضلا عن اقتراحاتك لتحسين هذه الأوضاع؟
بعد عودتي من الدراسة في الخارج عام 1978، تم اكتتابي في المعهد الموريتاني للبحث العلمي كباحث، ورفضت عدة مرات العرض المقدم لي لإدارة هذه المؤسسة، وذلك نتيجة شكي في إمكانية توافق صلابتي البيروقراطية “الأجنبية” الساذجة مع الممارسات الإدارية التي كانت تبدو مؤسسة على نوع من البيعة للقائد الأعلى في ذلك الوقت، مفاصلها شبكات قبلية وزبونية، لم تكن لدي شخصيا أي رغبة – ولا قدرة – في السعي إلى حشدها. ومع ذلك فإن إدارة بعض أسلافي، التي أفضل وصفها على سبيل اللباقة بـ”المشكوك فيها” ، أقنعتني بضرورة تحمل عبء تسيير المعهد وهو يحتضر. على الأقل من أجل الحفاظ على ميولي الشخصية للبحث. وعلى الرغم من كون الوسائل المادية و خصوصا البشرية لهذه المؤسسة جد محدودة، فقد كنت مع ذلك أعتقد أنه من الممكن أن نحاول “الحصول منها على شيء ما”. وتمكنت من ضم المتحف الوطني إليها، وكانت نتائج حفريات المعهد الأثرية الخاصة بما قبل التاريخ تغذي صالات عرض المتحف. وكنت أفكر في ذلك الوقت في القيام بعملية تجديد جوهرية لقاعات العرض بدعم من صديقة وزميلة ـ رحلت عن هذه الدنيا للأسف ـ هي دنيز روبرت، والتي كانت المهندس الرئيسي للمتحف وإحدى دعائم الحفريات الأثرية التي نفذت منذ عام 1960 في تاكداوست. كما بدا لي أن مجال النشر كان كذلك سانحا لبعض المبادرات التصحيحية، فأخذت على عاتقي بصورة خاصة، وبمساعدة من الباحثين في المؤسسة وزملاء آخرين، أن أبعث النشرة السنوية للمعهد من سباتها الذي دام عدة سنوات. وصدر عدد جديد من هذه النشرة بلغتين من المطبعة الجديدة تحت اسم جديد هو الوسيط، وبدا لي مستواه العلمي مقبولا، لكن صدوره تزامن مع “أحداث” 1989. كان ذلك العدد من الوسيط يحمل الرقم 3، ومن بين محتوياته مقال ليحي ولد البراء بعنوان التبعية عند الفقهاء الموريتانيين، وقفة تأمل (ص 122 – 145من جزئه العربي) تناول ـ من بين أمور أخرى ـ معالجة بعض الفقهاء المحليين في القرون الماضية لمسائل ذات صلة بالرق. موضوع محظور! قررت “السلطات العليا” بعد أن أبلغها أحد المتعاونين ” اليقظين” عدم نشر هذا العدد من الوسيط. وفي ذات الوقت بدأت الوزارة الوصية تمارس الضغوط بغية “تحويل” موظفين بولار من المعهد إلى الإدارة المركزية من أجل أن يفقدوا وظائفهم في إطار بداية التطهير العرقي داخل الإدارة الذي بدأته آنذاك حكومة السيد معاوية ولد الطايع. هكذا استقلت من المعهد الموريتاني للبحث العلمي رفضا للاستسلام لهذه الضغوط، واحتجاجا على مصادرة مجلة كلفت الكثير من الجهد والموارد.
إن هذه الحادثة الشخصية المؤسفة، رغم محدوديتها، تدل على أن مسألة حرية الفكر والتعبير تشكل واحدا من أهم مفاتيح البحث في موريتانيا، لكن هناك بالطبع قبل كل شيء، مسألة وسائل البحث المادية والبشرية، فمكانة الباحثين وطبيعة الصلات مع التعليم الجامعي، والموارد المالية، هي جزء، فيما أعتقد، من القضايا الرئيسية التي يتوجب علاجها إذا ما أردنا النهوض بهذا البحث.
– خارج الدوائر الأكاديمية، عرفت بقراءتك لحرب “شرببه”، فهي بالنسبة لك لم تكن صدام مصالح بقدر ما كانت حربا أخلاقية بين الإسلام “التشمشي” وقيم أخرى بعيدة عن قيم حسان، هلا شرحت وجهة نظرك للقارئ غير المتخصص؟
بالفعل قدمت أطروحة سنة 1985 خصصت جزءا كبيرا منها للحرب المعروفة بـ “شرببه”.او شرببه إن المواجهات المرتبطة بهذا الصراع في النصف الثاني من القرن 17 والذي لا يزال تسلسل أحداثها غير معروف بدقة، تُقدم في أغلب الأحيان، كما تعلم، على أنها نقطة الانطلاق أو أحد الأسس الرئيسية لتحقيق استقرار التعارض بين وضع الزوايا / حسان في جزء كبير من مجتمع البيظان، وتحديدا في منطقة الـﭬبلة “التشمشية” كما تقولون: حُظر حمل السلاح على المنهزمين، ثلث الماء، الضيافة، وصًل، الخ. وبعد محاولة تلخيص ما هو معروف من هذه الأحداث حسبما يعتقد، ركزت بالفعل في التصور الذي وضعته عنها، على دلالتها الثقافية والإيديولوجية في سياق ما أسميته “صراع التصنيف” بين القيم الدينية المرابطية وقيم المحاربين. واستوحيت من ابن خلدون ونظريته حول العصبية البدوية التي تمثل، على حد سواء، نواة الدولة ونقيضها، فحاولت أن أبين أنه إذا كانت أولى الإمارات، أي إمارة اترارزه، ظهرت عقب هذه الحرب فذلك إلى حد ما لأنها تجسد بداية توليف هذه القيم المتعارضة، قيمة العصبية “النقية” الانقسامية وقيم الإسلام، وهي بمثابة وعد بـ”تجاوز” (بالمعنى المقصود بفكرةAufhebung عند هيغل)،العداوات القبلية المحضة نحو إقامة نواة دولة. وعمد المغلوبون، الذين أضحوا متخصصين (ايديولوجيا) في ما أسميته “إدارة الغيب”، إلى فرض أو محاولة فرض هيمنة القيم الدينية التي يفترض أنهم سدنتها على “حسان” الذين يسيطرون على مقاليد الأمور السياسية، وذلك بفضل التازبه والكرامه والشفاعة، الخ. وكذلك بفضل الانتقاء بعد الوفاة (خاصة عن طريق المراثي مثل مرثية ولد رازكه لأعمر آكجيل…) لحسان “الجيدين” الذين قضوا، كما لو أنهم يريدون أن يقولوا للبقية “افعلوا مثلهم إن كنتم تريدون أن يكون لكم مصير مقبول في الآخرة! “
وكل هذه القضية كانت تبدو لي حينئذ، جزئيا على الأقل، غير بعيدة تماما عن نموذج ابن خلدون الذي يقول، كما تذكر: “إن العرب (يقصد البداة) لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوءة أو ولاية أو اثر عظيم من الدين على الجملة …”. ومن الواضح أن هذه الاعتبارات لا تمثل أكثر من إنارة خاصة لأحداث شرببه، كما أفضل أن أسميها مع محمد المختار ولد السعد، وهي أحداث متصلة بمجموعة من العوامل الأخرى (البيئية والديموغرافية والاقتصادية، الخ. )، والتي لا يزال، علاوة على ذلك، يكتنفها الغموض إلى حد كبير.
– ألا تعتقد أن الصدام بين القيم كان موجودا بين صنهاجه، وذلك قبل وصول حسان؟ كما أن ملاحظات ابن بطوطة في ولاته في القرن 14 توحي بوجود مجتمع أولى أن يوصف بالليبرالي، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأخلاق، وهو ما تسبب في إرباك الرحالة. ولكن مع ذلك كان هناك إسلام آخر أكثر صرامة في الشمال حيث كانت نواة تشمشه في آدرار، قبل هجرة أمغار الديماني إلى الـﭭبله.
أنت محق في إثارة مسألة أسبقية تشكيلة مجتمع بيظان ما قبل الاستعمار بـ”حسانه ” و”زواياه” و”لحمته”، بالنسبة لهذا المفصل التاريخي الذي يفترض أن تمثله شرببه. وفي الواقع كان ابن بطوطة لاحظ بانفعال أن نساء مسوفة إيولاتن – كما يسميهم – لم يكن لهن نفس وضع النساء “المسلمات حقا” في طنجة، مسقط رأسه. ولكن المسألة ربما لم تكن مسألة درجة “الليبرالية” أو “الهوية الإسلامية” بقدر ما هي مسألة نوع من أصناف القرابة. ويوصف مسوفه (اسم رأى فيه بابه ولد الشيخ سيديا والمختار ولد حامدن تشابها مع مشظوف المعاصرين عندنا…)، على غرار الطوارق المعاصرين، بأن لهم نظام قرابة ذا منحى أمومي خطي قوي (المنزلة وأهم الميراث كانا ينتقلان عن طريق الأمهات). وفيما يبدو لي فإن الأسلمة الثقافية لمجتمع البيظان، التي ظلت جد متفاوتة حتى اليوم، تطلبت عدة قرون، كما أن الطرق الصوفية، التي أصبحت مؤثرة لاسيما ابتداء من القرن 18، لعبت فيها دورا هاما. لقد أشرت في تعليقي على رسالة موجهة في شوال 898 / يوليو–أغسطس 1493 من المدعو محمد ب. محمد ب. علي اللمتوني إلى المؤلف المصري الشهير السيوطي، والتي أعاد هذا الأخير نشرها في الحاوي للفتاوي، أن هذه الرسالة توحي بأن ظهور تركيبة مجتمع البيظان الثلاثية المكونة من حسان وزوايا ولحمه ربما قد لا يكون انتظر وصول بني حسان، على الأقل إذا ما تأكدت الفرضية التي وضعتها عن المصدر الولاتي لرسالة اللمتوني. وهذا ليس رأي اثنين من أبرز المستعربين الإنجليز – جون هانويك (John Hunwick) وهاري ت. نوريس (Harry T. Norris)– اللذين يريان أن مخاطب السيوطي أولى أن يكون من نواحي اكادز ( Agadez)… ويبدو لي الجدل حول المصدر الصحيح لخطاب اللمتوني من الأهمية بمكان، لأن هذا النص يمثل، على حد علمي، أول شهادة يكتبها أحد السكان المحليين حول الهياكل الاجتماعية لصنهاجة غرب الصحراء…
– ألا يمكن العثور على مصدر هذه المواجهة قبل وصول حسان، على أسس مادية واجتماعية؟ فعلى سبيل المثال، أيام إمارتي ابدوكل و إنيرزيك، كان هناك في المدن الصغيرة نوعين ممن سيصبحون فيما بعد الزوايا، وخصوصا من بين التجار والقوافل التي كانت تعرف بداية تعليم ديني، قبل التقري مع إقامة “الرباطات” الأولى. ألا يمكن أن نعتبر هذا بمثابة بداية الانقسام الثقافي، مقابل الذي عرفه “الإمام آلمجذوب” في آدرار؟
مع قدوم التجار المسلمين أو “الدعاة” إلى المنطقة، أي على أقل تقدير منذ القرن الثامن تم وضع أسس المواجهة بين المسلمين الفاتحين والسكان المحليين حديثي الإسلام أو غير المسلمين على الإطلاق، في حين لم توجد، على حد علمي، حركات أسلمة أو إعادة أسلمة منظمة عسكريا ومعتبرة، غير حركتي المرابطين وناصر الدين.
ومع ذلك استطاعت الأسباب التي أدت إلى ميلاد هذه الحركات أن تغذي، ولا تزال تغذي، منافسات أضيق نطاقا وأقل تأثيرا. واستطاعت الخصومات التجارية والمنافسات الإقليمية وصراعات العصبيات في بعض الأحيان أن تأخذ صبغة دينية. ولا أعتقد بوجود “إمارة ابدوكل” أو “إمارة إنيرزيك “. الشيخ سيدي محمد هو الذي نسب ـ في الرسالة الغلاوية ـ لابدوكل امبراطورية في المناطق الصحراوية حيث كان بنو حسان قد شرعوا في بسط هيمنتهم، جاء ذلك في سياق رواية “مؤسسة” تهدف إلى إضفاء الشرعية على السلطة الخارقة لأسلافه، ولست متأكدا من أنه يمكن اعتبارها معطيات تاريخية بالمعنى الدقيق للكلمة. أما فيما يعني إنيرزيك ، فقد ورد ذكرها بالتأكيد باعتبارها جماعة قبلية مؤثرة قبل شرببه في جنوب غرب موريتانيا الحالي، لكن من غير المرجح إلى حد بعيد أن تكون أقامت شكلا من أشكال الحكم غير الذي أقامته القبائل المحيطة بها. وباختصار، إذا كنت قد فهمت مغزى سؤالك، فإن التعارض بين المحاربين والمرابطين كان على الأرجح قائما قبل حركة ناصر الدين وقبل معاصره الأقل منه نفوذا بكثير المجذوب، المدان مثله بنفس الشدة من قبل الطالب محمد ولد المختار ولد بلعمش، أهم فقيه سني في صحراء البيظان آنذاك.
– كثير من الناس يتبني النموذج الذي وصفت في إحدى كتاباتك بـ “نموذج اليدالي” والذي ينقسم فيه المجتمع إلى ثلاث فئات هي: رجال الدين (الزوايا) والمحاربون (حسان) والعبيد أو الأتباع. وبفضلك أنت وبفضل مؤلفين آخرين نعرف اليوم أن هذا النموذج يفتقر إلى الدقة. هل الأمر، حسبما تعتقد، يتعلق بهوية أنشأها المستعمر من خلال من كانوا ينظرون له مثل بوليى (Poulet) وإسماعيل هامت (Ismail Hamet) ولارتيغ (Lartig)؟ وإلى أي حد مكن هذا النموذج من ترسيخها؟
عذرا، لكنني لا أذكر أنني استخدمت مصطلح “نموذج اليدالي” . ومهما يكن، فإن الإيديولوجية التنظيمية التي تحكم تحديد “أصل” ووظائف “الفئات” الرئيسية الثلاث التي كان يتكون منها مجتمع بيظان ما قبل الاستعمار (حسان، الزوايا ، اللحمه) كان لها ـ بالطبع ـ بعد أدائي. لقد كانت تسعى إلى خلق هذه المجموعات بقدر ما كانت تسعى إلى التأكد من وجودها. وتاريخ هذه المجموعات يبين بالفعل أن تركيبتها كانت تشهد تحولات كبيرة، خلافا لفكرة “المولد” الجامدة التي تحدد مكانة كل واحدة منها في المجتمع، حيث هناك مجموعات كانت في الوقت ذاته تعد من “حسان” كما تعد من “الزوايا”، وكذلك يمكن أن يولد الفرد “حسانيا” ويصبح فيما بعد “زاويا” (جراء التوبة أو الهجرة)، كما يمكن أن يولد “حسانيا” ويصبح “لحميا” أو يولد “لحميا” ويكتسب مكانة “الحساني” ، الخ. كما أن الانتساب لـ”العرب” أو “البربر” أو “السود” لم يكن يلعب دورا حاسما في المسألة، فهناك “حسانيون” ينسبون لصنهاجة، وزوايا ينتسبون لبني حسان و لحمه ينسبون لهذا الأصل تارة ولذاك تارة أخرى، وما إلى ذلك. كما أن ادعاء الانتساب للعرب أو حتى الشرف وانتشاره على نطاق واسع ليس وليد اليوم، رغم أن تحرير سوق الأنساب فيما بعد الاستعمار أعطى دفعا قويا لهذا النوع من الادعاءات، وذلك في سياق لا أحد تقريبا يريد فيه أن ينسب لأصول بربرية…
ومما لا شك فيه أن الاستعمار استفاد من هذه الانقسامات، لكنني لا أعتقد أنه يمكن القول باختراعه لها، بل بمعنى ما، أدخل مع مدرسته ومع الفجوة الهرمية السحيقة التي تفصل جميع “السكان الأصليين” من جهة عن كل السادة المستعمرين من جهة أخرى، بذرة مساواة في الخضوع وفي الإزالة التدريجية للحدود بين مختلف “الفئات” (و هو ما تأسف عليه بالطبع”النبلاء” بمرارة ).
إذا كانت الحدود بين المحاربين والزوايا ضئيلة إلى هذا الحد، نظرا لأنها تتحرك دونما توقف نتيجة للزيجات “المختلطة” والمصاهرات و”التياب”، فإن الفصل بينهم يصبح من المستحيل تقريبا. كيف تعلل ذلك؟
على الرغم من تحوليتها التاريخية التي لا يمكن إنكارها، برهنت فئات المجتمع التقليدي الجامدة، والتي تشبه أحيانا بالطبقات الشعبية الهندية بسبب الشيوع النسبي داخلها لزواج الأقارب او بالتحديد فوق الكفوئ بالنسبة للنساء (hypergamie féminine[1]) وبسبب ميولها للتخصص المهني، برهنت حتى الآن على مقاومة باهرة. و يبدو الأمر كما لو كانت هناك مربعات فارغة، تجريدات، يريد الأفراد أو يشعروا بالارتباط بها، وإن كان، في الممارسة اليومية، تم محو الكثير من الصفات الملموسة لهذه الفئات. وفي الوقت الراهن أدى التحضر الواسع النطاق والتحولات في أنماط الحياة إلى تغيير جذري للأسس التي كانت تقوم عليها المنزلة التقليدية لكل فئة، وهي رغم ذلك أبعد ما تكون عن الاختفاء من المشهد. لقد أخذت مثال حسان والزوايا، وهاتان هما الفئتان المهيمنتان في مجتمع ما قبل الاستعمار، ولذلك فهما بالتأكيد ليستا الأكثر اهتماما بـ”الاستفادة” من شروط حل النظم التقليدية، إذ يمكن أن نفهم بسهولة أن عبد أو حرطاني أو امعلم (صانع تقليدي) أو إيقيو (مطرب) أو آزناقي (أحد الأتباع) يريد أن ينسى أو ربما “يعكس” الوصمة الاجتماعية التي تميزه في السياق الحضري والمهني الجديد المواتي إلى حد ما لمستوى من التحلل من النظم الاجتماعية السائدة][. وأما “النبلاء” أو من يدعون النبل فليست لهم مصلحة من هذا القبيل، خصوصا أن الاستعمار وتطورات ما بعد الاستعمار لم ينالا من هيمنتهم. وإذا كان لحاق البعض بالبرجوازية الحضرية الجديدة عامل مساعد في خلق طبقة من الملاك في مقدورها أن تستوعب بشكل هامشي بعضا من “ذوي النسب الجدد”، فإن معظم أعضاء هذه الجماعات، حتى وإن كانوا فقراء – وأحيانا عندما يكونوا فقراء بشكل خاص – يواصلون الدفاع باستماتة عن منزلتهم العائلية، ولاسيما من خلال الاستراتيجيات الزيجية التي يعتبرونها أهم الوسائل لصيانة المنزلة أو “الشرف”.
وإذا ما اقتصرت على مثالك المتعلق بحسان والزوايا، فحسب علمي وقع فعلا عدد من الزيجات “المختلطة” كما تقول، وكانت تقريبا على الدوام في اتجاه الزاوي الذي يتزوج من الحسانية، ونادرا ما يحدث العكس، كما لو كانت الشمولية وهيمنة القيم الدينية تستوجبان خرق قاعدة الزوج الكفؤ على حساب نساء المحاربين المسيطرين. فهل أصبح هذا النوع من التبادل أكثر شيوعا اليوم؟ هل مكنت (إعادة) أسلمة حسان وتقدم تعليمهم الديني مؤخرا من تطور مفهوم الكفاءة الذي كان في السابق يستخدم ذريعة لرفض زواج بنات “الزوايا” من “حسان”؟ وهل سجل على مدى العقود الماضية الكثير من الزيجات بين رجال من أرومة “حسان” ونساء من “الزوايا”؟ وبشكل أعم، هل فقد نموذج الزواج من ابنة العم هيمنته؟ أسئلة كثيرة تستحق الاستقصاء…
مؤرخ موريتانيا القرن 19، صالح بن عبد الوهاب يستحضر هجرة القبائل كعامل استقرار، وخاصة بمعنى أن القبائل، من خلال التحضر، تغير نمط حياتها الاقتصادية. ألا تعتقد أن هذا يتعارض مع رؤية ابن خلدون عندما يعتبر أن “العصبية”، عكس ذلك، تمثل عامل استقرار لأنها تنتج مجتمعا بدويا متجانسا؟
• أنا أتساءل عما إذا كنت تستخدم كلمة “هجرة” للتعبير عن مفهوم الهجرة المستخدمة من قبل صالح في الحسوة، على الأرجح فيما أعتقد، للدلالة على التحول من موقع “الحساني” إلى وضع “الزاوي”، ويجوز أن يكون هذا التحول في بعض الأحيان مصحوبا بالرحيل والاستقرار في أي بلدة مثل ولاته أو تيشيت. ولا يخفى عليك أن صالح وضع نفسه إلى حد ما “تحت رعاية” ابن خلدون عندما أكد في بداية كتابه إنه استشهد بمضمون بعض التوضيحات الخاصة بالنسب الموجودة “على هوامش” مخطوط لكتاب العبر. وبالنسبة لمؤلف المقدمة، كما أشرت، فإن العصبية الأكثر فاعلية تكمن، في الواقع، عند القبائل الرحل بسبب نمط حياتهم (بساطة المأكل والعدوانية والحياة خارج قبضة سلطة الدولة) و “النقاء” /إمكانية تتبع أنسابهم. وعلى العكس فإنه ينظر للمدينة كمذيب جينيالوجي حقيقي، مكان للاختلاط الخطير على النسب، حيث يستسلم البدو السابقون للترف و رغد العيش ويفقدون قدرتهم على الدفاع عن النفس، متكلين في ذلك على الأمير وأتباعه. وبصرف النظر عن وسائل الرخاء النسبية للغاية، بما في ذلك ولاته، مدينة صالح بالتبني (بين قوسين، المكان الوحيد في موريتانيا، حسب علمي، الذي كان يوجد فيه طبخ جدير بهذا الاسم)، فإن السياق الاجتماعي للمراكز السكنية الصحراوية الصغيرة، التي يقصدها صالح، لم يكن يميزها عن عالم الرحل من حولها.
ثم إن “تمدن” المقيمين منهم كان نسبيا للغاية لاعتماد جزء كبير من اقتصادهم على التنمية الحيوانية الرعوية. ولم يكن يوجد أي خطر ذوبان يهدد الهويات القبلية، نظرا على الخصوص لأحجامها الضئيلة ديموغرفيا (لا تتجاوز بضع مئات من السكان). وعلاوة على ذلك لم تكن ثمة أي سلطة للدولة يلجؤون إليها لضمان سلامة الأفراد والجماعات، باستثناء التدخلات المتأخرة لأمراء أهل عثمان وأهل امحمد شين وأهل لمحيميد، التي كانت دوما تتم على أسس قبلية، كما أن الصراعات والمفاوضات القبلية كانت على أي حال تتخلل تاريخهم الداخلي الخاص. وأستنتج من كل هذا أن رأي صالح، الذي أذكرك بأن الجينيالوجيا تمثل الخيط الموصل لكتابه (راجع العنوان : الحسوة البيسانية في الأنساب الحسانية) لا يتضمن، حسبما ما يبدو لي، أي تشكيك في نموذج ابن خلدون.
– ألا يعني ذلك أن العصبية الخلدونية قد تكون بدورها هوية وهمية؟
أنا لا أرى بوضوح منطق هذه التسلسل. كل ما يمكنني قوله هو أن ابن خلدون نفسه يؤكد أن النسب ـ الجينيالوجياـ الذي يؤسس عليه صرح العصبية بأكمله إنما هو مجرد “خيال” (النسب أمر وهمي، يكتب هو نفسه). وما يهم ليس قرابة النسب في حد ذاتها، بل “ثمرتها”، وهو ما يدل على أن هذا المفهوم الذي قام العلماء بتوسيعه إلى حد الحديث عن عصبية الديوان، عصبية “المؤسسة البيروقراطية “، لا يخلو من تعقيد.
– في أطروحتك “البداوة والإسلام والسلطة السياسية في مجتمع بيظان ما قبل الاستعمار” رفضت التفسير الاقتصادي لحرب شرببه المقدم من قبل المؤرخ الغيني بوبكر باري، وهي بالنسبة لك في المقام الأول صدام ثقافي. وكذلك يمكن أن يفهم من مقاربتك لعبد الله بن ياسين أن قيما جديدة تمكنت آنذاك من اختراق الصحراء، فهل تعتقد أن حرب شرببه قد انتهت؟
لقد تم اقتراح تفسيرات مختلفة لنزاع شرببه وقيل إنها كانت “أسطورة تأسيس” التفوق العسكري (تشارلز ستيوارت)، واختار بول مارتي أن يرى فيها قبل كل شيء التعبير عن صراع “إثني” بين العرب “النهابين” والبربر “المثابرين”. وقدم بوبكر باري في كتابه مملكة والو تحليلا لهذا النزاع مدفوعا في المقام الأول بانعكاساته على إمارات السود في منطقة نهر السنغال، حيث كان له تأثير كبير، واقترح، في إطار تحليل مستوحى من الماركسية، أن صراع شرببه تعبير عن التعارض بين ممثلين لمصالح التجارة عبر الصحراء (الزوايا) وممثلين لمصالح تجارة الأطلسي (حسان). ويرجع ذلك خصوصا إلى أن أنصار ناصر الدين كانوا يعارضون بيع المسلمين كعبيد في سوق سانت لويس (خدمة لهدف غير معلن يرمي، حسب تفكير باري، إلى توجيههم للمبادلات التجارية “الإسلامية” عبر الصحراء). وحاولت أن أبين أوجه القصور في هذه المقاربات، ربما بشيء من الإفراط. واليوم بعد نحو ثلاثة عقود مرت منذ ذلك الحين، أود أن أكون أكثر تمحيصا، لأن هذه المقاربات المختلفة لا تخلو على كل حال، حسبما أعتقد، من بعض الحقائق. كما تشيرون فقد ركزت فعلا في وجهة نظري الخاصة من هذا الصراع على بعده الأيديولوجي، وكنت أحسبه حركة مهدوية جاءت في سياق مهول وربما على خلفية جفاف مدمر، وحيث القيم الدينية التي رفعها أنصار شبه-النبي الذي كان ناصر الدين يمثله، تشكل رافعة (لا)مادية قوية للغاية. ومن الممكن أن يكون وعظ بن ياسين الموفق جاء في سياق مماثل حيث الصراعات بين العصبيات المتنافسه (صنهاجه والزناته ولمتونه واكداله، الخ.)، تتخللها مجموعة من العوامل الأخرى (أزمة بيئية وغذائية وصعوبات تؤثر على المبادلات عبر الصحراء والهجرات القبلية والتوترات الداخلية في إمبراطورية غانا وضواحيها الصحراوية، الخ.)، هذه الصراعات قد تكون ساهمت في ظهور حركة المرابطين. أنت تسألني إن كنت أعتقد أن حرب شرببه انتهت، لكن هل هي وقعت أصلا؟
من المرجح أنه باستثناء عائلات بعض المتعلمين في الـﭬبله “التشمشية” كما تقول، لا يوجد الكثير من الناس بين السكان الموريتانيين اليوم القادرين على تحديد موقع هذه الأحداث وطبيعتها ، غير أنه يبدو لي أن سؤالا آخر يفهم من وراء سؤالك: ماذا في الوقت الراهن عن المنافسات بين الزوايا وحسان والتي يفترض أن شرببه كانت بمثابة نقطة تحول فيها؟
للرد على هذا السؤال، أود أن أقترح الأجوبة التالية: أن الاستعمار الفرنسي استند أساسا، خدمة لإدارته، على هذه الطبقة الخاضعة من المجموعات المهيمنة، أي “الطبقة الوسطى المكونة من المرابطين” اذا كنا نستطيع استعمال هذا التصنيف في غير محله إلى حد ما، ومن الواضح أن العناصر المهيمنة من الطبقة الأرستقراطية المحاربة لم تكن لترضى عن ذلك القرار. كما أن سلطات ما بعد الاستعمار كانت تنتسب في جزء كبير منها لهذه الطبقة الاجتماعية “الزاوية”، ولمنطقة الـﭬبلة على نطاق واسع. أما بالنسبة لنواة جيش مرحلة ما بعد الاستعمار، فيبدو لي، على النقيض من ذلك، أن جزءا كبيرا من هيئة تأطيره كان من “حسان” السابقين. ورأى بعض المراقبين في انقلاب عام 1978 نوعا من “انتقام” “حسان” من “الزوايا”، على الرغم من احتمال تدخل العديد من العوامل الأخرى (القبلية والإثنية والجهوية وورطة نزاع الصحراء وما إلى ذلك). لقد سمعت البعض، بمن في ذلك أساتذة جامعيون من أبناء “حسان”، يستخدمون هذه الأنماط التفكيرية للتعبير عن رضاهم أو سخطهم إزاء الأفراد والجماعات والقرارات الإدارية، إلخ، معتقدين أن التصنيف بخصوص “حسان” و”الزوايا” ما زال قابلا للاستخدام. وربما لم يكونوا مخطئين تماما، خصوصا بالنظر إلى وزن التضامن/المنافسة الجهوية التي عادة ما تحشد التحالفات المحلية بين هذه القبيلة “الحسانية” وتلك القبيلة “الزاوية”. من الممكن أيضا أن تكون هذه التصنيفات في طريقها لتصبح خالية من أي مضمون ملموس داخل هذا الخليط الاجتماعي الجديد الذي تكون في مدينة نواكشوط، مع الاستمرار في خدمة استراتيجيات تصنيف رمزية ومادية لم تعد في الواقع لتتصف بـشيء يمكن أن نسمه بصفة “زاوي” أو “حساني”.
– هل يمكن من وجهة نظر تاريخية أن نعتبر الاتجاه الإسلامي الموريتاني بمثابة نهضة لمشروع ناصر الدين؟
على الرغم من أنني لست مطلعا بما فيه الكفاية على حقيقة هذا الاتجاه، فأنا أميل إلى الرد بالنفي، لأن مشروع ناصر الدين كانت له جذور محلية قوية وكان، من الناحية الثقافية، فيما أعتقد، من محض إنتاج جنوب غرب الصحراء، و له امتداده الراسخ في المحيط القبلي و مرتكزة على سلطة غيبية و على خوارق و كشف ومعجزات ذلك الولي. وبالفعل يحتمل أن يكون شمل، بشكل هامشي، بعدا أصوليا بامتياز، من قبيل، على سبيل المثال، عزل النساء في حيز منفصل، حسب ما رواه اليدالي، لكنه، فيما أعتقد، يختلف راديكاليا بما فيه الكفاية عن الأصولية اليوم. وهذه الأخيرة، سواء كانت سلفية جهادية أو وهابية أو غير ذلك، تبدو لي كأحد الأوجه المعاصرة للعولمة، وأحد طموحاتها وملامحها الرئيسية يكمن في محاولة الفصل بين الثقافة والدين. وهي تساهم بطريقة ما في “الاستعمار الثقافي عبر الكوكاكولا[]” أو “عولمة الماكدونالدز[]” – “عولمة ماكدونالدز” حلال إلى حد ما – شاملة تهدف إلى إزالة كل خصوصية ثقافية محلية لإجبار المعمورة بأسرها على اعتناق إسلام سلف متخيل بتطبيق نفس المعاملة على السلوك الغذائي وشعر الجسم والملابس والفنون والسلوك الجماعي والفردي عبر الكوكب بأكمله. وهذا، على ما أعتقد، بعيد بما فيه الكفاية عن مشروع ناصر الدين…
.
– لماذا جاء ظهور الإسلام-السياسي في موريتانيا “متأخرا” إلى هذا الحد، أي في تسعينيات القرن العشرين؟ هل يعني ذلك أن الإسلام العلماني، الذي لا يحتمل سلطة دينية، كان مسيطرا؟
يتوجب علي الاعتراف مرة أخرى بأنني قليل الإطلاع على حقيقة الاتجاه الإسلامي الموريتاني، ويرى العديد من المراقبين لهذه الظاهرة في التوجه الإسلامي الذي يجتاز العالم العربي منذ بعض الوقت، تعبيرا عن الارتباط بين مصالح برجوازية “ورعة” من أبرز شخصياتها الأيديولوجية (القرضاوي مثلا…) التي تركز على الدوائر المالية “الإسلامية” العالمية (مجالس الشريعة للهيئات المصرفية التي تدعى “إسلامية” ، الخ.) وشباب ريفي نازح إلى المدينة و محبط، هذا بالإضافة إلى الوضع الدولي حيث غطرسة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والدعم غير المشروط الممنوح لها من قبل الدول الأوروبية والأمريكية المعروفة بكونها معاقل للديمقراطية على مستوى العالم، وهو تصرف يشي بـ”النفاق” المهيمن والكيل بمكيالين، نهج “الطاغوت” كما يصفه السلفيون.
وفي موريتانيا، أعتقد أن الموجة الأولى من الهجرة إلى المناطق الحضرية قد أنتجت حركة الكادحين في السبعينيات، وبالتأكيد فإن استمرار تلك الاضطرابات المناخية والاجتماعية ساهمت في تطور السلفية.
ولم يضعف سيل النزوح منذ ذلك الحين، خاصة نحو نواكشوط، لتحتضن العاصمة في الوقت الراهن قرابة ثلث السكان الموريتانيين، وقد رافق الاستيطان والتمدن ارتفاع غامض في مستوى التمدرس. ومع الإصلاحات التي كان الهدف منها تعريب – بل ربما يجب أن نقول محظرة – التعليم العمومي، اتسعت القاعدة الديموغرافية لهذا الأخير على نطاق واسع، كما أصبح أكثر انفتاحا على الفئات التي لم تكن تستفيد منه تقليديا: النساء وأبناء الطبقات المسحوقة في مجتمع ما قبل الاستعمار (لحراطين).
ومع ذلك فإن نحو 60 ٪ من “ضحايا” محو الأمية هذا في مرحلة “ما بعد التزاويت”، يتم طردهم من النظام المدرسي في نهاية المرحلة الابتدائية مع استمرار النزيف خلال المراحل التالية، ففي هذا العام (2011)، أعلنت السلطات “بفخر” أن ما يزيد قليلا على 10 ٪ فقط من المرشحين اجتازوا امتحان البكالوريا … وأنت تعلم، في الطرف الآخر، مصير الخريجين من التعليم العالي الذين لا يستطيعون إيجاد أي وسيلة للتوظيف، والذين تزداد أعدادهم يوما بعد يوم، مع العلم أن أزيد من 70 ٪ من السكان لا تزيد أعمارهم على 25 عاما. هذه هي التربة التي نشأ عليها إسلاميو موريتانيا، وربما بشكل متأخر قليلا عن باقي بلدان العالم العربي والإسلامي، نتيجة حداثة التمدن/التحضر و التوسع الإسلامي أساسا (وكذلك القاعدي) للنظام المدرسي.
– هل تعتبر أن مبدأ العلمانية، الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، هو ضرورة ديمقراطية وشرط لبناء قيم الجمهورية؟
يبدو لي الأمر كذلك. إذا كانت الديمقراطية هي التعبير الحر عن تعدد الآراء الفلسفية والدينية والسياسية وما إلى ذلك، فلا أرى كيف يمكنها أن تتناغم مع الهيمنة المعمول بها في نظام واحد من الفكر الديني والفلسفي والإيديولوجي. فالديمقراطية تتطلب حياد الدولة بالنسبة للانتماءات والمعتقدات والمواقف التي تؤسس لبنية المجتمع المدني وعادة لتقسيمه. غير أنه من الممكن أن تكون فكرة العلمانية صعبة التأقلم في عالم الثقافة الإسلامية، نظرا لطموح هذه الملة لتكون دينا ودولة على حد سواء، نظاما كاملا لإدارة السلوك الفردي والجماعي، وهذا على الرغم من مكتسبات التجربة التركية، والتونسية بدرجة أقل.
– بعد وقت قصير من الانقلاب الذي قاده في أغسطس 2008 الجنرال ولد عبد العزيز، نشرت نصا سبب ضجة كبيرة في الأوساط السياسية الموريتانية. في هذا النص تطالب بخروج الجيش من الميدان السياسي. ما هو موقفك بعد ثلاث سنوات؟ وهل لا يزال الجيش يشكل عقبة أمام الديمقراطية؟
أنت ربما تشير إلى المقال الذي طلبه مني موقع الجزيرة نت والذي لم يكن موجه بصفة خاصة للقارءالموريتاني ثم نشره موقعكم. أنا لا أتعاطف مع الانقلابات العسكرية والانقلابيين، ومع ذلك لا أشعر بأنني كتبت “نداء”، أعتقد أنني اقتصرت أساسا على سرد موجز للظروف التي قام فيها السيد محمد ولد عبد العزيز بعزل السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله بعدما عمل على وصوله إلى السلطة، أي باختصار الصراع المعروف والذي اكتسى صبغة برلمانية في ظاهره. وللرد على الجزء الثاني من سؤالك، فأنا لا اعتقد أنه يمكن القول إن الجيش يشكل دائما عقبة في كل مكان أمام الديمقراطية، فالجيش جزء من السكان ويواجه نفس الصعوبات ونفس المشاكل. وهو على الأرجح يعرف نفس الانقسامات و تأثير الولاءات العرقية والجهوية والقبلية والطبقية، الخ. وقد يكون مصدر حركة تمرد ذات طابع ديمقراطي أو بمثابة فتيل لهذه الحركة. ومع ذلك فإن سلوكه الذي يقوم على تقديس الانضباط والطاعة وعلى القيم و السلامة “الوطنية” التي يفترض أن يدافع عنها حيثما كانت فكرة الأمة تحظى بنصيب من الرسوخ، هذا السلوك يجعل الجيش في أغلب الأحيان مسكونا بالسلطوية وميالا حتى إلى الفاشية عندما يسعى قائده أو قادته لفرض السلوك الخاص بالجيش على المجتمع برمته باعتباره سلوكا “مثاليا نموذجيا”.. وهذا هو ما كانت تطمح له نوعا ما فكرة هياكل تهذيب الجماهير في عهد هيداله. ولكن حتى في هذه الحالة كان مبدأ الحساب كأساس للبنية الهرمية لهياكل تهذيب الجماهير ( 10 عائلات تشكل “حيا”، و 10 أحياء “منطقة”، الخ.) أفضى من خلال نوع من “مكر العقل” إلى بعض النتائج “الديمقراطية” التي لم تكن متوقعة، فلم يمكن مثلا – على الأقل في حالة عاينتها أنا شخصيا (في بكل شمال كيهيدي) – من تجنب تأكيد الهيمنة الديموغرافية للحراطين في بعض الأماكن مقارنة بـ “أسيادهم” حيث كان “البيظان” أقلية بشكل واضح…
– تواجه الديمقراطية الموريتانية عددا من المشاكل منذ بعض الوقت، هل تعتقد أن ذلك راجع لأسباب سياسية بحتة؟
كما تعلم، فإن إقامة سلطة تعددية راسخة ومستقرة تطلبت في كثير من الأحيان وقتا طويلا في جميع أنحاء العالم. وكان عادة ما يرافقها مستوى من التنمية الاقتصادية والثقافية وظهور مؤسسات وهيئات وسيطة (جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية، الخ.) ينتهى بها المطاف إلى خلق مؤسسات من خلالها تتجه السلطة للحد من السلطة (جمعيات تداولية، جهاز قضائي يتمتع بمستوى ما من الاستقلالية،…). أنا أعتقد أن فكرة الديمقراطية، في مهدها في أوروبا، رافقها أيضا جنبا إلى جنب ظهور مبدأ حقوق الفرد مع فكرة حريته في التفكير التي أطلقها الفكر الفلسفي المعاصر عن طريق التفكير الديكارتي. وهذا المفهوم للاستقلالية العقلية والإرادية للفرد تعرض بطبيعة الحال للانتقاد على نطاق واسع، كما أشار نيتشه وفرويد وماركس كل على طريقته، أن لست أنا من يفكر كما اعتقد ديكارت بل “يتم التفكير بي ” (“إرادة القوة”، العقل اللاواعي والانتماء الطبقي). ومع ذلك فمن دون المرور بمربع الفرد هذا فإن مفاهيم من قبيل التصويت (“رجل واحد، صوت واحد”) والدخول وراء الستار للاختيار وحرية الانتساب للأحزاب السياسية، إلخ، كل هذه المفاهيم ليس لها كبير معنى. وفي موريتانيا، على الرغم من التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي حدثت منذ أوائل السبعينيات، لا أشعر شخصيا حتى الآن بوجود أرضية مناسبة بشكل كبير للديمقراطية. وحسب ما أعتقد فإن تأثير الهويات الجماعية “المحلية” (العائلة والقبيلة والجهة والعرق،…) بالإضافة إلى التقاليد والدين، لا يزال يشكل عقبة كأداء أمام المكونة التحررية/ الفردانية للديمقراطية. أضف إلى ذلك الأمية (على الأرجح أكثر من 50٪ من السكان البالغين) والفقر، وستحصل على بعض العناصر الأساسية التي تفسر روح الرضوخ بل طلب الاستبداد الملاحظ في جميع أنحاء موريتانيا خلال نشوة الانقلابيين. لكن حذار! فهذا لا يعني عدم وجود تطلع عميق للعدالة بين الموريتانيين، أو عدم وجود بعض الأقليات التي تدافع بشجاعة عن الديمقراطية. ما أعنيه هو أنه، حسب علمي، لا يبدو لي أن أغلبية السكان الموريتانيين قابلة للتعبئة حول أفكار من قبيل الحرية والمساواة. وبالتالي فإن المشاكل التي تواجه ” الديمقراطية الموريتانية “، كما تقول، مشاكل اجتماعية قبل أن تكون سياسية.
– منذ سنوات، أصبحت موريتانيا هدفا للإرهاب أو الإسلام الراديكالي، ما هي الأسباب في رأيك؟ وما هي أفضل وسيلة للقضاء عليه؟
لقد أعطيت جوابا أوليا لهذا السؤال فيما تقدم من حديث. وحسب ما يبدو لي فإن الأصولية أو التطرف الديني ليس مسألة محلية، موريتانية أوشيشانية أو في حزام الكتاب المقدس (Bible Belt) في جنوب الولايات المتحدة. بل هي ظاهرة عالمية ومتناقضة إلى حد ما، وتعكس في ذات الوقت التقدم الذي تحرزه محاولة “تحويل العالم إلى قرية واحدة” إعلاميا وثقافيا والأزمة التي تجتازها القيم الكونية المنبثقة عن التنوير، والتي مثلت الماركسية ترجمتها الأكثر راديكالية وانتشارا خلال القرن المنصرم، إضافة إلى حجم المبادلات الدولية للسلع والأشخاص، وسرعة وسائل الاتصالات التي لم يسبق لها مثيل، هبت معها على الهويات الحقيقية أو الوهمية ريح قوية من التوتر، دفعت بالدين إلى الواجهة. كما أن هناك الأصولية المسيحية (في اللغات الأوروبية، هذا المصطلح نفسه من أصل أبروتستانتي) واليهودية والهندوسية وغيرها. وفي نسختها الإسلامية، استعادت هذه الحركة الفكرية كذلك بعضا من موضوعات السبعينيات لـ “مناهضة الامبريالية” و”العالم الثالث” والتي “عفا عليها الزمن” بسبب انهيار الشيوعية والمنحى غير المشرف الذي اتخذته معظم الأنظمة “المناهضة للامبريالية” في العالم الثالث. لقد منحت نفسها بكل سرور دورا رائدا في الدفاع عن الأراضي الإسلامية ضد الهيمنة الخارجية وفي القضية الفلسطينية، وما إلى ذلك. وكذلك فإن طوائف جهادية من هذه الحركة، يقودها رجال مصممون و بدون وازع، يمكن أن توفر ملاذا روحيا لشبان هامشيين ذوي ماض قضائي مشوب، يجدون فيها وسيلة لإضفاء الشرعية على أنشطة إجرامية مربحة لصالح “قضية مقدسة”، تماما مثلما جندت جبهة التحرير الوطني علي “لابوانت” في معركة الجزائر العاصمة. وبخصوص الحالة الموريتانية، والتي لا تختلف كثيرا عن غيرها، فإن إحباط الشباب في ظل عدم وجود آفاق للمستقبل، إلى جانب سلطة مشكوك في شرعيتها ويطبعها الفساد، يمكن أن يستمر في توفير أرضية للاكتتاب وحجة لأكثر الأعمال وحشية. وعلى الرغم من أن الحركة الجهادية الدولية الأولى، حركة بن لادن وأتباعه، كانت من فعل شبان “برجوازيين تقاة” (أطباء ومهندسين وطلبة…)، يبدو أن فرعها الموريتاني يكتتب أساسا من الوافدين الجدد إلى المدينة من الفئات المحرومة في المجتمع التقليدي. وربما ليس مصادفة أن يكون الانتحاريان الوحيدان اللذان سجلا حتى الآن في موريتانيا من الحراطين.
سألتني كيف يمكن التغلب على هذه الظاهرة، في الحقيقة أنا لا أعرف الكثير عن ذلك، ورغم أن تأثير موريتانيا على البعد الدولي للقضية لا يمكن إلا أن يكون ضئيلا، يمكن مع ذلك التكهن بأن تحسنا كبيرا في المناخ الاجتماعي (التعليم، العمل، الصحة، الخ)، بعيد الاحتمال في المستقبل المنظور للأسف، قد يساهم في تجفيف المنبع الذي تنهل منه الجهادية.
– كيف تنظر إلى منزلة المرأة في موريتانيا؟ هل تعتقد أنه سيكون من الحكمة تغيير قانون الأحوال الشخصية الموريتاني؟
يقال أحيانا إن وضع المرأة البيظانية يجعلها في حال أفضل بكثير من نظيراتها في بقية العالم العربي والإسلامي. إن هذا الاستنتاج، الذي لا يشمل لا الحرطانيات ولا الزنجيات (أي غالبية الموريتانيات) ، قد يكون ذا صلة بالتراث الثقافي القديم، وخاصة النسب الأمومي الخطي المذكور أعلاه، وهو النسب نفسه الذي يفسر، على سبيل المثال، ندرة أو شبه المنع العرفي لتعدد الزوجات في الطبقات العليا من مجتمع البيظان. وبشكل عام، فإن التقاليد مع ذلك تمنح المرأة الموريتانية مكانة قاصر. وحسب علمي، فإنه يبدو لي أن التشريعات الحالية قد عكست على نطاق واسع هذه المكانة وأقرتها، على الرغم من بعض التحسينات. وقد نتوقع أن يحمل التقدم الحاصل في مجال التعليم حضورا مكثفا للمرأة في العمل وفي مناصب المسؤولية في الإدارة، وما إلى ذلك. لكنني، رغم عدم امتلاكي لمعلومات دقيقة، لا أعتقد حتى الآن أن هناك جهودا حثيثة من جانب السلطات العمومية في سبيل تحقيق المساواة، باستثناء الترتيبات الانتخابية التي تقررت غداة انقلاب 2005. كما كان على التحضر الواسع، أو على الأقل التعاظم السكاني لمدينة نواكشوط خلال السنوات الأربعين الماضية، أن يساهم في النهوض بتحرير المرأة. ” يقول ماكس فيبر إن “المدينة تحرر” . لكنني أخشى أن يكون هذا التأكيد يحتاج إلى تمحيص في حالة نواكشوط. وبالمقارنة مع التنوع النسبي، من حيث الجنس، الذي عرفته في الخيمة البدوية أيام طفولتي، فإنني أشعر أن منزل المدينة المغلق، وخصوصا الفيلات الباروكية الضخمة للبرجوازية الجديدة “الورعة”، قد توفر فرصا جديدة لحبس النساء وعزلهن، وخلق خدور (حرم) منفصلة، على النموذج الخليجي، الغريب نوعا ما على التقاليد المحلية. وربما كنت أنت صغير السن في أواخر 1980 إبان النقاش الذي سببه موقف المغفور له محمد الامين ولد سيدينا الذي كان يدافع عن المصافحة الحرة في تلك الفترة. ويبدو أن هذا الجدل قد أظهر على وجه التحديد صعوبة الانتقال من أسلوب حياة ريفية تطبعها البداوة إلى عالم متحضر يعرف تضخما مستمرا وربما للأسف! “خلجنة”، والعقل الليبرالي الذي أطمح اليه لنفسي مؤيد بالطبع لتحرر المرأة ومساواتها، وليس فقط في موريتانيا، غير أنه ليس من المؤكد أن هذه الدعوة ستخدمها كثيرا، ولا حتى أن تكون أغلبية النساء الموريتانيات تريد حقا هذه المساواة!
– ما هو رأيك حول العبودية في موريتانيا؟ وماذا تقترح لوضع حد لهذه الممارسة؟
لقد سبق أن قدمت بعض الملاحظات حول مشكلة الرق في موريتانيا في مطبوعة أو اثنتين، والمسألة معقدة و”مؤدلجة” للغاية، وهو بطبيعة الحال ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع أي مقاربة يراد لها أن تتصف بأدنى مستوى من الموضوعية، كما أنها معتمة بعض الشيء بفعل صلاتها “السمراوية” مع المشاكل الإثنية التي تهز موريتانيا من وقت لآخر منذ منتصف الستينيات، والتي تميل غالبا إلى تقديم مشكلة الرق على أنها جانب من “مشكلة السود” بصفة عامة.
والرق، في المكونات المختلفة للمجتمع الموريتاني، بدون شك نظام قديم قدم هذه المجتمعات نفسها، وكان، عند الناطقين بالحسانية، يخص أفرادا ذوي بشرة أكثر سوادا من لون أسيادهم البيظان، بينما لم يكن واضحا بنفس الدرجة لدى مجتمعات السود، وإن كانت آثاره واقعية تماما مثل الأول. والبيظان، كما تعلم، كانت غالبيتهم العظمى من البدو الرحل قبل بداية الثمانينيات، وإذا كان الاستعمار قد فرض إلغاء الرق في الواقع على السكان المتقرين في جنوب البلاد، وهم أقدم وأكثر خضوعا لإدارته المباشرة (الضريبة الفردية والتجنيد وبداية تمدرس أكثر تطورا، الخ)، فقد غض الطرف عن هذا النظام عند البيظان، مكتفيا بالسهر على قمع الاتجار بالإنسان كبضاعة، ومع ذلك فإن الوجود الاستعماري سيمهد الطريق بشكل غير مباشر لبداية التحرر. والسكان الأوائل الذين استوطنوا القرى التي أنشأها المستعمر (روصو، المذرذر ، بوتلميت ، ألاك، أكجوجت، امبود ، كيفه، لعيون)، كانوا مكونين إلى حد كبير من العبيد السابقين الهاربين، والذين كانوا يستطيعون العثور فيها على وظائف صغيرة تتماشى نوعا ما مع وضعهم السابق (خدم منازل ، عمال يدويون، جزارون، خبازون، الخ) .
وقبل الاستعمار بوقت طويل حدث الفصل بين الأسياد الرحل والمزارعين التابعين، نوعا ما تحت طائلة إتاوات تدفع لـ “أسياد” القبيلة، وقد تعزز هذا الفصل خلال الحقبة الاستعمارية. وللتذكير فإن الأرض كانت ملكا للقبيلة في النظام التقليدي، وعموما لم يكن بالإمكان التمتع بها إلا في هذا الإطار. والعمل الزراعي في آدوابه وفي الواحات كان يمثل جزءا أساسيا من نشاط العبيد والحراطين، أما في مخيمات البدو فبالإضافة إلى رعاية الماشية وجلب الماء، كان العبيد يتولون الأعمال المنزلية، وكانت ظروفهم الذاتية، المشرعة بالنسخة المحلية من الشريعة ، تتراوح بين وضع الدواب المدربة على حمل الأثقال، يعانون من سوء الغذاء والملبس ويعاملون أحيانا بوحشية سادية، إلى منزلة الصديق المؤتمن على الأسرار ورفيق السلاح وشبه القريب (نتيجة قرابة الرضاعة من بين أمور أخرى). :كما أن مصيرهم كان يختلف حسب أقدميتهم في الأسرة المالكة (نانمه، التربية) وحسب مكانة هذه الأسرة (نبل العبد من سيده) .
لقد توارت مشكلة الرق في مجتمع البيظان منذ نهاية الفترة الاستعمارية إلى بداية السبعينيات، مع أنها شهدت مع ذلك تشديدا في المعاملة، بما في ذلك حالات بيع للعبيد بسبب الأزمة المناخية والاقتصادية الخطيرة، بداية الأربعينيات. وعلى الأرجح فهذه الوضعية لم تكن بمعزل عن غزارة الأمطار في تلك الفترة التي شهدت نموا كبيرا لمواشي البدو الرحل ومستوى من الازدهار النسبي للإنتاج الزراعي، مما مكن سكان آدوابه من التخلص من إلحاح “أسياد” القبيلة والعيش من عملهم بكرامة نوعا ما. وقد أدى الجفاف الكبير في بداية السبعينيات، وما صاحبه من نزوح كبير من الريف نحو المدينة و استقرار فيها، إلى التسريع الحاسم بفصل العبيد عن أسيادهم بعد أن أفلستهم الظروف المناخية وشدة التوتر بين الطرفين حول ما تبقى من الأراضي الزراعية القابلة للاستصلاح. وستقوم بعد ذلك بطرح مشكلة الرق من جديد حركة الكادحين وبعدها حركة الحر، وكلا الحركتان من نتاج هذه البيئة، من بين أمور أخرى. ثم تعقدت المشكلة بعد اتخاذها منحى عنصريا (التوترات الإثنية – العنصرية لسنة 1989 …) وإقليميا (النزاع الموريتاني – السنغالي…) ودوليا (الصحافة الدولية وجمعيات حقوق الإنسان، الخ…).
ومن الصعب تقديم تقدير دقيق لما تبقى بالتحديد حتى اليوم من العبودية كنظام بعد الإلغاءات المختلفة التي كان موضعا لها (1980 ، 2007). وينبغي الاستناد إلى تعريف دقيق للمقصود من “العبودية” وإجراء التحقيقات اللازمة، والتي، على حد علمي، لم يتم إجراؤها بعد، فالأرقام التي نراها من وقت لآخر في الصحف لا تستند بشكل عام، فيما يبدو لي، على أي أساس جدير بالتصديق.
وكلما يستطيع علم اجتماع تقريبي أن يرسخه هو أن الحراطين، الذين يمثلون الغالبية العظمى من العبيد السابقين في الوقت الراهن، وربما ما يناهز نصف الناطقين بالحسانية، ما زالوا يحملون الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وضعهم السابق كأتباع. وفي المناطق الريفية، سمحت لي الدراسات الاستقصائية التي أجريتها شخصيا بين عامي 1978 و 1995، أن أرى أن نفاذهم إلى الأراضي الأكثر خصوبة (الواحات، السدود ، إلخ)، كان محدودا للغاية، حيث كانوا يحتلون أساسا وظائف العمال اليدويين والمزارعين المستأجرين. أما في المدن، فكانوا يمثلون السواد الأعظم من الفقراء ويمارسون الأعمال الأكثر صعوبة والأدنى أجرا. وعلى الرغم من المشاركة في النهب المنظم لـ”امتيازات” الدوائر العليا للدولة التي يمكن في بعض الأحيان لحديثي النعمة من بينهم أن يستفيدوا منها، لا يوجد أثرياء كبار من الحراطين. وإذا كان حضورهم في عالم السياسة قد شهد بعض التقدم على مدى العقود الثلاثة الماضية، إلا أن تمثيلهم يظل ناقصا باعتبارهم “إثنية” منفصلة، كما يريد البعض من قادة الرأي من بينهم، لأنهم يعتقدون، وهم في ذلك محقون إلى حد ما، أن لغة الإثنية تبدو في الوقت الحاضر، مع الانتماءات القبلية، الأكثر “مردودية” لدى عرضها على الرأي العام الموريتاني.
إن علاج الآثار النفسية والاجتماعية للعبودية (العنصرية والاحتقار والاستبعاد من الزواج، الخ.) غير ممكنة فيما يبدو لي قبل فترة (جد) طويلة، ما لم تأت الظروف بثورة اجتماعية. ومع ذلك فإن جملة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة والموجهة نحو ترقية تلك الفئة (تنفيذ إصلاح عقاري حقيقي وآليات قرض محددة، الخ.) يمكن أن تساعد على التقليل من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الحراطين، ومن ثم تخفيف التوترات التي تولدها هذه الصعوبات أو التي يمكن أن تولدها في المستقبل.
– وكذلك، ما هي رؤيتك للمسألة الوطنية في موريتانيا؟ هل تعتقد مثلا ان هناك عنصرية ضد الأفارقة السود في موريتانيا؟
•
لقد جمع التقطيع الاستعماري، الذي رسم حدود موريتانيا الحالية، معظم الناطقين بالحسانية في الصحراء الغربية مع قسم كبير من السكان السود لحوض نهر السنغال: البولاريون والسوننكيون والولوف في هذه البلاد التي أسماها الفرنسيون موريتانيا. وقبل فترة طويلة من الاحتلال الاستعماري نفسه، كان الفضاء الموريتاني لعدة قرون مستقطبا إلى حد كبير حول سانت لويس (Saint-Louis) السنغالية، وهي مركز تجاري أنشأه الفرنسيون ابتداء من 1659. ويمكننا، تتبع التبادلات التجارية والثقافية بين شعوب حوض النهر وجيرانهم الصحراويين في فترات قبل ذلك التاريخ، بما فيها أيام امبراطوريات الساحل الكبرى، غانا ومالي. . وبالطبع فإن هذه التبادلات لم تستبعد النزاعات والحروب، بانتصاراتها ونكساتها وانتقال السيطرة إلى يد هذه المجموعة أو تلك ذات المكونات العرقية واللغوية الأكثر تمكنا شيئا ما، والصور النمطية العنصرية، التي رافقت هذه السيطرة أو تلك، قديمة على الارجح قدم المجموعات المتصارعة نفسها. انظر، على سبيل المثال، شكوى ابن بطوطة من الازدراء الذي كان، في رأيه، يعامل به فاربا حاكم ولاته المالي (الأسود) “البيض”…. وأنا لم أعثر، في أي من الوثائق التاريخية التي قدر لي أن أطالعها، على نزاع أو حرب على أسس عرقية بشكل صريح، كما أن التحالفات الحربية “متعددة الأعراق” لم تكن نادرة، بدءا بتحالفات المرابطين. كما أن “الإثنيات” والعرقية بمعنى “العنصر” كلها من نتاج التطورات المعاصرة والاستعمارية ومرحلة ما بعد الاستعمار.
كما قلت لك فقد جرى احتلال موريتانيا وتأسيسها كمستعمرة من الجهة الجنوبية وتم إخضاع سكانها المستقرين السود (الولوف ، والبولاريين والسوننكيين) قبل الناطقين بالحسانية وبشكل أقوى (أي بشكل مباشر أكثر منهم). بعد تدخل فيدربFaidherbe ، منذ 1857، بدأ الاحتلال الفرنسي لحوض السنغال واكتمل سنة 1891، بينما لم يتسن اعتبار الاستيلاء على منطقة جنوب الصحراء في موريتانيا مكسبا قطعيا ومستتبا إلا في أوائل ثلاثينات القرن العشرين، وتم تجنيد سكان المناطق المحتلة تدريجيا للسيطرة على باقي السكان. وكانوا يحصلون على بعض الفوائد من هذا التجنيد، رغم أنهم تصدوا له في السابق بنفس المقاومة التي يواجهه بها جيرانهم قيد الإخضاع. وهكذا، على سبيل المثال، كان السكان المستقرون في حوض نهر السنغال أفضل استفادة بقليل من المدارس الفرنسية من جيرانهم الناطقين بالعربية ، فكان وجودهم أقوى في الدوائر التقنية للإدارة (الصحة والتعليم والبيطرة والمياه والغابات والأرصاد الجوية، الخ.)، خصوصا أن بعض هذه الخدمات بقيت موريتانية – سنغالية حتى عشية الاستقلال. ومع ذلك، فعلى الصعيد السياسي خلقت إدارة المستعمر الظروف لهيمنة البيظان الجلية، وخاصة فئاتهم المسيطرة، على باقي المجموعات، فقد اتبعت إلى حد ما في توزيع وظائف الإدارة العليا شبه القاعدة غير المكتوبة المتمثلة في الكسر “ثلاثة أرباع / ربع واحد”، والتي تبنتها بعد ذلك سلطات ما بعد الاستعمار مباشرة. وفيما بعد تدخلت عوامل مختلفة أدت إلى اختلال هذا التوازن الهش والذي لم يكن يرضي الأوساط القومية “الزنجية” و “العربية” بما فيه الكفاية. ثم جاءت الاضطرابات المناخية أواخر ستينيات القرن العشرين وما خلفته من تقر واسع النطاق للبدو الرحل وتنافس قوي على الأراضي الزراعية والمراعي والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) والعمالة الخ…. ولدى بدايات تعريب النظام التعليمي، المترتب خصوصا على زيادة الطلب على التمدرس من قبل المستقرين الجدد، رأت فيه العناصر المتعلمة من مجتمعات السود تهديدا لهم، لأنهم كانوا يميلون إلى النظر إلى اللغة الفرنسية باعتبارها أكثر ملاءمة لوجودهم في الدوائر العمومية، السياسية والمهنية على حد سواء. كل ذلك أدى إلى توترات لا تخلو من ديماغوجية قوموية، تعتمد أسلوبا تخيليا نوعا ما للتلاعب بأحجام “الإثنيات” وحتى بطبيعات هذه “الإثنيات” وحدودها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بـ”هوية” العبيد السابقين في مجتمع البيظان… ثم جاءت مواجهات 1989 التي فبركتها إلى حد كبير السلطات في ذلك الوقت (والسلطات السنغالية بدرجة أقل)، لتكمل المنعطف المأساوي الذي أخذته هذه المنافسات، مزيحة الستار عن بداية التطهير العرقي الإداري على خلفية مختلف أنواع الابتزاز والنفي على نطاق واسع ضد المواطنين الموريتانيين من مجموعات الزنوج، بما في ذلك عدد من حالات القتل خارج نطاق القانون طالت بشكل خاص صفوف الجيش. ويبدو لي أن هذه التطورات قد خلقت وضعا يمكن للموريتانيين المنحدرين من أصول زنجية أن يعتبروا فيه أنفسهم اليوم، وبحق، ضحايا حالة من التمييز.
– تحتدم المواجهة بين رجال القانون حول عقوبة الإعدام، التي يطالب العديد من الناشطين بإلغائها. ما هو موقفكم؟
نحن مدينون، حسب ما أعتقد، لفلاسفة التنوير للجهود من أجل إضفاء الطابع الإنساني على أشكال الانتقام من المجرمين. وهذا الاتجاه الذي استهدف كلا من التعذيب و الانتقام العادل المشتق من القصاص، سجل تقدما معتبرا منذ القرن 18. وأعتقد أنه يمثل تقدما خلقيا لا يمكن إهماله للإنسانية ككل، على الرغم من أنه من الصعب، أمام جرائم بشعة للغاية، أن لا نحس بالرغبة الشديدة في الانتقام التي يولدها، مع شيء من الارتباك، هذا النوع من الجرائم.
– كيف تقوم حرية الصحافة وبصفة عامة حرية التعبير في موريتانيا؟
بقدر ما يمكنني وضعي في المنفى ومراقبتي للأمور عن بعد أن أبدي وجهة نظري بهذا الخصوص فيبدو لي، على الأقل في الظاهر، أن الصحافة تتمتع بقدر معتبر من الحرية، ولكنها بالتأكيد ملجمة عن طريق الرقابة الذاتية المندمجة على نطاق واسع في العقلية السائدة، وهي عقلية “قبلية” و “دينية / سلطانية” على حد سواء. وإذا كانت الإدارة على الأرجح لا تأنف عن أية فرصة للنيل من صحيفة مثل صحيفتكم تعمل بشجاعة على إرساء حرية التعبير، فإنها كذلك تستطيع الاعتماد على الرقابة غير الحكومية، الرقابة “الشعبية” التي تمارس من خلال أشكال التعبئة الجماعية، بالاعتماد على أنواع التضامن البدائية التي لا تزال حية إلى حد كبير، تغذيها العصبية. فإذا فضحتم قضية فساد، لأسباب وجيهة، فأنتم لستم أبدا في مأمن من الانتقام القبلي، لأن العصبية نفسها تعمل كنوع من التأمين الذي يوفر فوائد من الفساد وكذلك أعمالا انتقامية في حالة الإبلاغ عن هذا الفساد.
– كيف تقيم المشهد السياسي الموريتاني؟
سؤال واسع! إذا كان “التقويم” بالنسبة لك يعني “التحليل والفحص”، فبضع صفحات لا تكفي لمحاولة تفكيك الروابط المتعددة والمعقدة بين أصحاب السلطة والتشكيلات الحزبية المعارضة لهم مع محددات المشهد السياسي الموريتاني: الإثنية، القبيلة، الدين، “النظام” التقليدي، الطبقة الاجتماعية / الفئة الاجتماعية والمهنية، الأجيال، مستوى التكوين ولغته، الطريقة الصوفية، الولاء المذهبي، مكان الإقامة، الوشائج والصلات الدولية، الخ. إن الوزن الخاص بكل واحد من هذه العوامل وتعريفه، موضوع نقاش لا يزال مفتوحا بين علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع والسياسة (ما ذا تعني القبيلة تحديدا؟ ما هي الإثنية؟ ما هي الطبقة الاجتماعية؟هل توجد طبقات اجتماعية فردانية في موريتانيا؟ ما هو وزن الانتماء الطبقي، إذا كانت هناك طبقات، مقارنة مع الانتماءات القبلية والإثنية، الخ؟).
أما إذا كنت تقصد بـ”التقييم”، إصدار أحكام بشأن عمل الفاعلين على الساحة السياسية في موريتانيا وتوجهاتهم، فأنا لا أشعر بأنني مؤهل للقيام بذلك. وبما أنني لست بأي حال من الأحوال طرفا في هذه المواجهات، على الرغم من أن لي رأيا مثل الجميع، فأنا أخشى كثيرا أن أتبنى الموقف الذي نسبه في السابق سارتر للأخلاقي الكانطي : يقول إن له أياد بيضاء لأنه لا أيادي له….
– يقال عادة إن القرن 19 كان قرن الثورات في فرنسا والولايات المتحدة، كما يقال عن القرن 20 إنه قرن الثورات الروسية والصينية، أما القرن 21، فهو مرشح ليكون قرن الثورات العربية. ما هو تقييمك للربيع العربي: أسبابه وخصوصا انعكاساته على العالم العربي؟ هل تعتقد، على وجه الخصوص، أنه سيكون من المشروع التمرد ضد النظام القائم في موريتانيا؟
لقد تابعت باهتمام بالغ تطور الحركة التي أدت إلى سقوط أو اهتزاز أحكام المستبدين العرب، من سليلي الأسر الحاكمة في الجمهوريات الزائفة أو من يحاولون إرساء سلالات حاكمة جديدة، تأسست على تبديد الأموال العمومية والتخويف بالمخابرات، أو برجال مسلحين. وللوهلة الأولى، كان هذا الغليان الذي لا تزال نتائجه غير مؤكدة، يتجه نحو دحض الرأي “الثقافوي” القائل بأن العالم العربي والإسلامي غريب وراثيا إلى حد ما على أفكار من قبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلخ؛ والطريقة التي بايع بها الشعب الموريتاني، بحماس ظاهر، مختلف “سلاطينه” منذ قدوم الجيش جعلتني شخصيا أعتقد أن هذا الرأي الثقافوي لا يخلو من بعض الأساس. كما أن التمعن في ما تم تدوينه بخصوص أحكام السلطة (الأحكام السلطانية للماوردي، على سبيل المثال) وبعض “مرايا الأمراء” (ابن المقفع، المرادي الحضرمي، الغزالي، الطرطشي، الشيخ سيدي محمد، الخ.) وقصص (كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة، الخ.)، يدل فيما يبدو على وجود مكامن عميقة للتبعية في الإرث المؤسسي والثقافي العربي الإسلامي، تدعمها أخلاقيات الطرق الصوفية التي أثرت بشكل عميق على التقاليد الإسلامية المحلية ( المثل الأعلى للمريد / جثة في يد شيخه مثل الميت في يد مغسله…)، مما يعني أننا جميعا مماليك، من حيث الأساس! وبالطبع فإن هذا التراث الثقافي يتطور ويتغير. والثورات العربية تبدو، كما قلت، مصدر إلهام لأشكال مماثلة من الاحتجاجات في أنحاء أخرى من العالم، كما نلاحظ أنه حتى في البلدان التي يبدو فيها النسيج الاجتماعي أقرب إلى النسيج الاجتماعي للرأسمالية المعاصرة، أي في تونس ومصر، فإن سقوط الديكتاتور لا يعني بالضرورة التفكيك الفعلي لجهاز سلطته. وهذه الثورات فيما يبدو تمهد الطريق خاصة لأحزاب ذات إلهام ديني تحمل البذور القديمة لطلب الاستبداد “السلطاني”. وعلى الرغم من بعض التحركات، فإنه لا يبدو، على الأقل بالنسبة للمراقب البعيد مثلي، أن رياح التمرد وصلت بقوة معتبرة إلى موريتانيا. وعلى أية حال، إذا أراد الموريتانيون حقا التمرد ضد قادتهم، فإنني سوف أجد ذلك، من ناحيتي، أمرا لطيفا للغاية، رغم أنني لست مقتنعا بأن المملكة العربية السعودية وقطر قناة الجزيرة، حيث تجد الإسلاموية جزء أساسيا من مصادرها / مواردها، لست مقتنعا بأنها ستكون محجات، إن صح هذا التعبير، للديمقراطية التعددية .
– من هي الشخصية التاريخية التي أثرت عليك، على مر تاريخ البشرية؟
ليس لدي تماهي مع شخصية بطل معين. والمشكك المسن الذي أمثله يميل إلى الحذر من الأبطال، ما لم يكونوا يوفرون بعض الأسس للتشكيك في بطولاتهم، مثل سقراط، البطل الأسطوري النهم للاستجواب الفلسفي.
– هل أنت مهتم بالسينما والموسيقى؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم الفنانون المفضلون لديك؟
في الحقيقة، لست مهتما كثيرا بمثل هذه الأمور، في زمن صباي البعيد، كانت لي بعض الميول تجاه موسيقى الجاز وكنت مهتما ببعض السينمائيين السوداويين أو “أصحاب الحلول الخيالية” (برغمان Bergman، فلليني Fellini، بونويل Bunuel.. ) والمخرجين ممن ينتمون لما يسمى بـ”الموجة الجديدة”، خصوصا غودار Godard. ومع التقدم في العمر، استعاد محيطي الثقافي تدريجيا نوعا ما طبيعته “المرابطية”، مقتصرا على الكتب بشكل حصري تقريبا.
– ما هو آخر مشاريعك الأكاديمية ؟
• لدي الكثير من أفكار الترجمة/النشر القديمة للعديد من النصوص التي تبدو لي ذات أهمية في التقاليد الثقافية في غرب الصحراء. وفي الوقت الراهن إذا استطعت أن أكمل عملا تجميعيا بدأته عن موريتانيا، يكون ذلك عملا لا بأس به.
– هلا حدثت قراءنا عن قراءاتك الأدبية (خارج الميدان الأكاديمي)؟
أنا من نتاج مدرسة الاستعمار الفرنسي، واهتماماتي الأدبية تحمل طابعها. لقد كان من الواجب معرفة الأعمال “الكلاسيكية” في مجالات المسرح والرواية والشعر وتقاليد المدرسة الفرنسية. وفي وقت لاحق شملت هذه القراءات مؤلفين من جميع الفئات، لكن يجب أن أقول إن قراءاتي الأدبية بشكل خاص تضاءلت إلى حد كبير على مدى العقد الماضي، حيث كان وقت الفراغ الذي يسمح لي به التدريس مكرسا في المقام الأول للمخطوطات الصحراوية ولقراءات أكثر تجريدا في مجالات كالأنثروبولوجيا والفلسفة. وهناك على الأقل مؤلف لم أتوقف عن التردد عليه بسبب اختصار نصوصه وزيف نبوغها الميتافيزيقي، هذا المؤلف هو خورخي لويس بورخيس Jorge Luis Borges.
– كيف تقيم الساحة الثقافية في موريتانيا؟
أنا للأسف لست مطلعا بما فيه الكفاية على تطور المشهد الثقافي في موريتانيا، ما أراه على الإنترنت يقودني إلى الاعتقاد بأنه موجه إلى حد كبير باعتبارات دينية. ومع ذلك يوجد به الآن مغنو راب وفنانون تشكيليون وكتاب شباب… على أي حال أنا أقدر حيوية وذكاء النصوص التي تكتبونها أنتم شخصيا، أبو العباس وحنفي، لموقعكم، وكذلك بعض المساهمات الأخرى التي قرأتها عليه.
– هل حدث أن راجعت آراء كنت قد عبرت عنها؟
أنت لم تكن تتوقع، على ما آمل، أن أجيب بـ “لا”! أنا أتبنى بعمق مبدأ بوبر الذي يريد، خلافا للمعتقد أو الإيمان، أن تكون السمة الأساسية لنتائج البحث هي قابليتها الأساسية للبطلان. والحقيقة العلمية، عكس الدين أو المذهب أو الأيديولوجيا، يتم الإعلان عنها وتعرف بقبولها حتما للمراجعة، كما أنها تعترف سلفا باحتمال إظهار حدودها، بل زيفها. وهذه طريقة أخرى ، بالنسبة للباحثين، للتعبير عن التأكيد السقراطي القديم، الذي أتبناه عن طيب خاطر: “أنا لا أعرف إلا حقيقة واحدة، وهي أنني لا أعرف شيئاً “.
====
نشرت المقابلة لأول مرة على تقدمي الخميس, 10 تشرين2/نوفمبر 2011