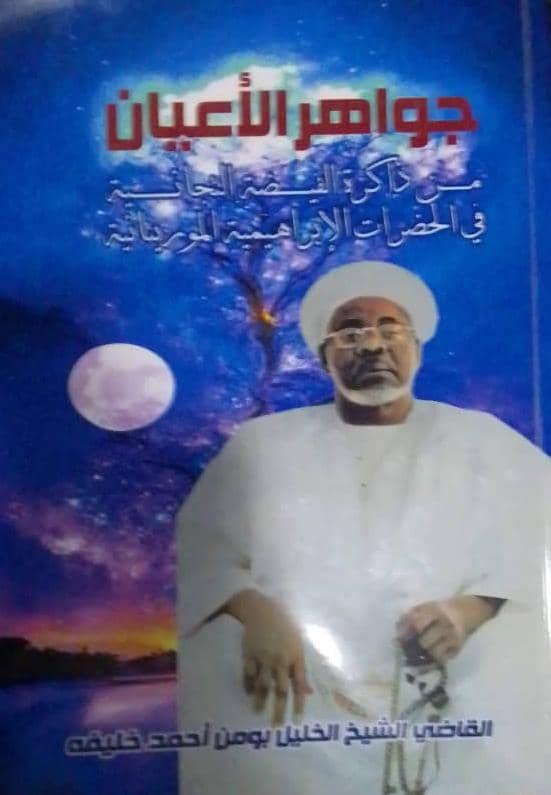يمكن إدراج رواية “القاسم ولد الحسين”، ضمن الرواية الاجتماعية، أو التي تُعرف باسم رواية الخمسينيات، إذ ظهرت الرواية الاجتماعية في إطار الواقعية الاجتماعية، ضمن الأدب الذي ظهر في الخمسينيات بعد سلسلة من التغييرات الاجتماعية والسياسية التي حدثت في العالم العربي، كـ”ثلاثية” نجيب محفوظ.
وتتكون رواية “القاسم”، من سلسلة من النصوص السردية التي جاءت ضمن النص على شكل أجزاء، لتعبر عن سلسلة من التغييرات التي شهدتها حياة البطل “القاسم”؛ ضمن الـ175 صفحة من الحجم المتوسط؛ والتي جعل فيها الشيخ نوح، شخصية “القاسم” نافذة أبجدية يطل منها القارىء على الشخصية الموريتانية؛ بساطتها، سذاجتها، جمالها وقبحها في الآن معًا، مستعملا في ذلك قدرته على الكتابة بمشرط الجراح أو بـ”السكاكين” كما يقول هو.
فعندما تقتحم النص، فإنك تدخل عالمًا روائيًا، يشبه إلى حد ما موريتانيا التي نسمع عنها، نعرفها من خلال ما نقرأ ونتابع، فهي كالوصف الذي اختلقه نوح أبجديًا لـ”القاسم”، “في بحة صوته الجهوري وخزات من إبر الزمن، ولسعة من مفتتح الشيخوخة”، (صفحة 11)؛ ومن خلاله كان يصف موريتانيا، كما يراها الشيخ نوح شخصيًا، الشيخ الذي يبحث عن طوفانٍ ينتقل ببلاده إلى مصاف الدول التي يحترم فيها الإنسان وتعاش فيها الحياة التي تشبه الحياة!.
في هذا النص، يصوغ الشيخ نوح، صورًا موريتانيةً قوية؛ من خلال خطابه الموريتاني المحض، تتطابق موريتانيا مع أمريكا اللاتينية، التي أبدع غابرييل ماركيز في صياغتها أدبيًا؛ ففي هذا المكان من العالم؛ ظل القاسم يرتحل من البساطة إلى النذالة إلى الحقارة فالطيبوبة، الشخصيات المزدوجة هوياتيًا، لدى ماركيز، ولكنها تبقى رغم ازدواجها وانشطارها شخصية ثابتة؛ فالإصرار على شخصية “القاسم” وذريته الممزقة بسياقات مختلفة؛ كان مذهلًا، فهو نوع موريتاني خاص وخالص؛ وبيظاني عمومًا؛ فنحن نتفرق على خارطة الحيوات لنلتقي على خارطة الأوجاع؛ نحن الذين تاهت هوياتهم بين الدين والعروبة وإفريقيا؛ بكل قبح ذلك وجماله، بعذوبته وعذابه؛ حتى صار محكوم علينا في المحصلة؛ بأن نكون كـ”القاسم” كل شيء ممكن، حتى تشابهت مسيرته التجارية رغم اختلافها مع تجارة الجنس لدى مومسات ماركيز، وتجربته العشقية التي طاردته كاللعنة مع تجربة “ريكاردو” في رواية “شيطنات الطفلة الخبيثة” لـ”ماريو بارغاس يوسا”.
إنها رواية تجب مساءلتها بعد ممارسة فعل “قتل المؤلف” كما شرعنه “رولان بارت”، “هل فعلا وقعت هذه الأحداث في الواقع أم في الخيال”، أنا على يقين أنها حدثت ربما في تلك المنطقة التي يتزاوج فيها “الواقع بالخيال”، ليصبح صورًا متخيلة تبحث عن “القاسم” في كل منا بشكل أو بآخر، وعن “حليمة” والحب المشتهى والمقتول، بتفاصيل أخرى!..
القاسم هو أنا وأنت وكل قارىء، والشيخ نوح معنا، فلو لم يفترق دمه حبرا بين دفتي رواية هي الآن تعيش حياتها خارج سلطته، فما “كان ذلك يهدي فرصةً لكاتب ما لزيادة رفوف المكتبات برواية جديدة” (الصفحة 171)..
في هذا العمل، عانقت الشيخ نوح، كما أوصى في الإهداء، ليس لأنه طلب ذلك؛ فقد عانقته من خلال “القاسم”، من خلال الرواية التي كانت منجمًا؛ تكمن ثروته في الطريقة التي يصبح بها الأشخاص الحقيقيون الذين يعرفهم الروائي أو نعرفهم نحن في الحقيقة، والذين تحولوا بعمق من خلال ذاكرته وخياله، ومن خلال تأويلاتنا للنص، من أشخاص بعينهم، إلى شخصيات أدبية ذات طبيعة مختلفة عن كل شيء؛ حتى عن الحقيقيين الذين مغنطهم في النص أثناء الكتابة وقفزوا إلى رؤانا أثناء القراءة؛ وذلك هو البرزخ الذي ما يفصل بين الذي يوجد دائمًا في الواقع الذي نعيش فيه والخيال الذي تبنى عليه الرواية، فـ”الرواية هي ابنة المجتمع، ابنة الوطن، وليست ابنة المواقع الغربية”، كما تقول “حميدة نعنع”.
سعيد المرابط، صحفي